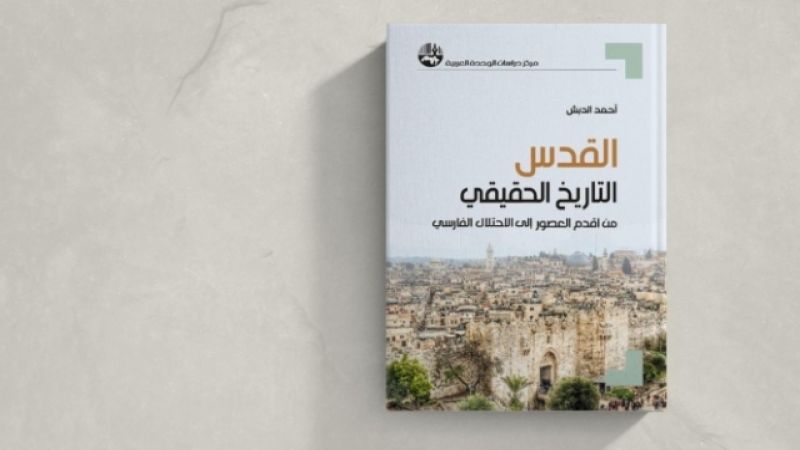قضايا وكتب
قراءة في كتاب: القدس.. التاريخ الحقيقي من أقدم العصور إلى الاحتلال الفارسي
المؤلف: أحمد الدبش
العنوان: القدس، التاريخ الحقيقي من أقدم العصور إلى الاحتلال الفارسي
بيروت، حزيران/يونيو 2020، الطبعة الأولى، عدد الصفحات 254
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
مراجعة: شوكت اشتي
-----------------------------------
يُثير عنوان الكتاب، منذ البداية، تساؤلات مشروعة، مع أنه يبدو، من حيث المبدأ، واضحًا وصريحًا ومباشرًا. فهل يستعرض المؤلف "التاريخ الحقيقي" للقدس في فلسطين؟ ولماذا؟ أم يحاول أن يُبين أن التاريخ السائد غير حقيقي، ما يفرض كتابة تاريج "جديد" و"حقيقي"؟ أم أنه في سياق عرضه لتاريخ القدس، يكشف للقارىء حقائق غير معروفة، الأمر الذي يسهم في كتابة تاريخ حقيقي للقدس في فلسطين؟ كما أن إيغال الكتاب في عمق التاريخ، يزيد التساؤل ولا يخفيه؛ بمعنى آخر هل من الضروري العودة إلى كل هذه الآلاف من السنوات لكتابة التاريخ؟ وكيف؟ ولماذا؟
منطلقات أساسية
تتوضح هذه التساؤلات مباشرة من الأسطر الأولى من مقدمة الكتاب. إذ ينطلق المؤلف، من سؤال أساس: هل نستطيع كتابة تاريخ القدس؟ وتاليًا، هل يمكن تحرير تاريخ فلسطين القديم، ومن ضمنه تاريخ مدينة القدس، من "ماضٍ خيالي"، فرضته الدراسات التوراتية؟ أي أننا أمام معضلة ترتبط بتشويه الحقائق، وأزمة ترتبط بتصورات خيالية وأوهام ترتبط بغير المعقول ومعطيات لا علاقة لها بالواقع، ما يجعل القارىء، ومنذ البداية أمام تحديات معرفية صادمة من عمق المعطيات التي يُقدمها الكتاب، والتي تكشف التزييف الذي يعتمده العدو، وتُبين الحقائق التي يوجد من يعمل جاهدًا على طمسها وإنكارها لغايات سياسية وإيديولوجية.
من هنا؛ يقودنا المؤلف إلى عمق التاريخ لإعادة تصويب مساراته وتحديد آثاره ورسم معالمه، بعيدًا عن التشويه والتزوير والتحريف والتعامي، مستندًا إلى العديد من المراجع والوثائق والمعطيات الدامغة والاكتشافات الأثرية، مع قلتها وصعوبة الحصول عليها، لنعرف تاريخ مدينة القدس على حقيقته من دون أي لُبس، ولنستعيد "قوة الشخصية الحضارية الفلسطينية"، ودورها الإنساني الذي يحاول العدو تهميشه وصولاً إلى إلغائه، تحت ذرائع واهية وحجج قسرّية، وتسميات ساذجة من "الكتاب المقدس".
الأقسام الرئيسة
يتوزع الكتاب على أربعة عشر فصلًا، عدد صفحات كل منها قليلة قياسًا لحجم الفصول عادة. لكن هذا "الخلل" الشكلي جدًا، كان مُفيدًا للقارىء؛ لأنه وفرّ إمكان التعمق في كل عصر من هذه العصور الغابرة، وعدم الارتباك في تداخلها. وعليه؛ فقد بدأ باستعراض الموقع الجغرافي لمدينة القدس والحفريات الآثرية فيها، وبدايات السكن فيها، لينتقل إلى متابعة كل عصر من عصور التاريخ، بدءًا من العصر البروزي المبكر إلى الوسيط، والمتأخر إلى اختلاق كلمة "أورشليم"، إلى القدس في العصر الحديدي ومملكة الورق والحروب باتجاه القدس، وظاهرة "أورشليم" المرَضية، والاحتلال الفارسي وإدعاء "العودة اليهودية"، وتوضيح من هم سكان القدس في هذا المسار التاريخي الطويل.
لذلك؛ الكتاب لا يهمّ أصحاب الاختصاص فقط؛ بل تطال فائدته الأجيال الطالعة والمهتمين بالشأن العام، لأنه يوضّح للقارى، وعبر العديد من المحطات التاريخية، مدى التشويه الذي يحاول الصهاينة إحداثه عبر هذا التاريخ، لتأكيد مقولاتهم العنصرية وتسويغ همجيتهم في القتل وارتكاب المذابح لاحتلال فلسطين وتزييف تاريخ مدينة القدس، في محاولة لمصادرتها وتغيير معالمها.
تأكيد الهوية
إذًا نحن أمام نص صادم، فقد عمد العديد من المؤرخين والباحثين، بوعي، أو من دون وعي، إلى الانجرار وراء "المزاعم التوراتية المُسبقة" لاقتلاع الجذور الفلسطينية من فلسطين عامة، ومدينة القدس خاصة. ولم يكتفِ العدو باحتلال الأرض، بل عمد إلى تفعيل عملية ضرب الهوية الفلسطينية، باعتماد قضم المزيد من الأراضي، وتوسيع حركة الاستيطان على حساب الماضي والحاضر. وكل ذلك بهدف "متخيّل"، وغير واقعي مستندًا إلى "الرواية التوراتية" التي ساعدت العدو على كسب ادعاءاته المزيفة والمغلوطة تجاه فلسطين وتسويقها.
وعليه، يأخذ الكتاب خطًا سياسيًا واضحًا وصريحًا ومباشرًا، ومن دون أي تمويه، لتحقيق هدفين على الأقل: الأول، لإثبات زيف الإدعاءات الصهيونية حول فلسطين عامة، ومدينة القدس خاصة. وثانيًا، لتأكيد الهوية المسروقة عمدًا متعمدًا من العدو الصهيوني. لذلك سيجد القارىء بهتان العديد من المعطيات المتداولة، والسائدة، الأمر الذي يساعد في إعادة تصحيح التاريخ.
الجغرافيا والحفريات
تتمتع مدينة القدس، بموقع استراتيجي. إذ ترتفع عن سطح البحر 830 مترًا، في الحد الأقصى. وتقع على عدد من التلال عددها 5، وتحيط بها ثلاثة أودية وأربعة جبال، ما يُعطيها حصانة طبيعية. ويبدو أن الانبهار بالأرض المقدسة (فلسطين) قديم جدًا. إذ يعود إلى القرون الأولى للمسيحية، الأمر الذي دفع العديد من الباحثين إلى استكشافها. وبدأ الحجاج المسيحيون، منذ القرن الثاني الميلادي، يأتون إلى فلسطين لتعقب خطوات المسيح وحوارييه. غير أن هذا الحج أخذ بُعدًا آخر، تمثل في "التنقيب الأثري" لتأخذ توجهًا مسكونًا بـ"هوس ديني بالتوراة"، بهدف استعمار فلسطين وتحويلها إلى أرض التوراة.
هذا التوجه ارتبط بالدوائر الاستعمارية واليهودية، خاصة بعد انتهاء الحروب الصليبية، فجعل عمليات المسح والاستشكاف، لاحقًا، موضع شك من السلطات العثمانية. وذلك؛ لأن بعض الجمعيات لجأت إلى الاحتيال للدخول إلى الحرم القدسي الشريف بحجة وضع "تخيّلاتهم" حول مكان "الهيكل المزعوم"، لدرجة أن إحدى البعثات البريطانية، في العام 1818 التي رفضت السلطات التركية إعطائها "الإذن الرسمي"، عمدت إلى الحفر ليلًا، ما دفع السلطات لبناء جدران في موقع الحفر لمنع المزيد من التنقيب.
وبعد دخول نابليون بونابرت إلى مصر، ثبت أن هذه التنقيبات "مكيدة دولية"، لإضفاء "الشرعية على مصالحها الإمبريالية" مُستخدمة العلوم (علم التاريخ، علم الآثار) لخدمة هذه العملية. لذلك جرى "إفراغ تاريخ فلسطين، والتاريخ الفلسطيني من أي معنى حقيقي". وقد استمر في القرن التاسع عشر مسلسل الرحلات الاستكشافية، من الجنسيات الأميركية والأوروبية المختلفة، حيث اعتمدت هذه الرحلات على إسقاط "النصوص المقدسة" على الواقع إسقاطًا قسريًّا.
في هذا السياق، يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى ما كشفه بوضوح تام رئيس اساقفة بورك/بريطانيا، من موقعه رئيسًا لجمعية "صندوق استكشاف فلسطين". فبعد صلاة افتتاحية، أوضح أن من أهداف هذه الجمعية والتوجهات المستقبلية لمسار عمليات المسوحات والتنقيب التأكيد أن "فلسطين لنا". إذ قال في هذا الاجتماع إن :"هذا البلد فلسطين عائد لكم ولي، إنه لنا أساسًا". فقد مُنحت، "فلسطين إلى أبي إسرائيل"، مُرددًا، "هيا إمشِ في الأرض طولاً وعرضًا، لأني سأعطيك إياها"، ويتابع: "نحن عازمون على المشي عبر فلسطين، بالطول والعرض، لأن تلك الأرض مُنحت لنا...". وعليه، تكلفت هذه الجمعية بتحقيق مجموعة من المسائل/الأهداف من أبرزها:
- تحديد موقع هيكل اليهود.
- تحديد سنة إنشاء قبة الصخرة المشرفة.
- تحديد موقع كنيسة القيامة.
- تحديد أبواب المدينة القديمة المشار إليها في التوراة وفي كتابات يوسيفوس.
- تتبع جدران القدس الثلاثة التي وصفها المؤخ اليهودي يوسيفوس.
إنطلاقًا من هذه التوجهات/الأهداف، عمدت الجمعية، لاحقًا، إلى إرسال ضابط بريطاني إلى فلسطين للتنقيب في القدس، وفي منطقة الحرم القدسي الشريف بالتحديد. لكن ومع تكرار محاولات التنقيب، على مدار عدة سنوات، وفي 2 حزيران العام 1897، أُغلقت هذه "الحفريات المقدسة"، للمرة الأخيرة، لأنها لم تصل إلى كشف أي "إدعاء توراتي". وهذا بحد ذاته دليل قاطع على الهوس السياسي ببعده الديني، والذي لا تزال الحركة الصهيونية وكيان الاحتلال، يسعى لإيجاد دليل ما في القدس، لكن من دون جدوى. وبالرغم من هذا الفشل، العدو يعمد إلى تضليل الرأي العام بأوهام لا صحة لها.
حفريات لاحقة
في بدايات القرن العشرين، توهم البعض بمعرفة مكان تابوت المهد وكنوز سليمان، وادّعى جوفيلوس أنه اكتشف "شيفرة سرية" في الكتاب المقدس، ترشدهم إلى مخبأ تحت المعبد المقدس فيه كنوز سلميان، والتي تُقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولا أمريكي. وبالرغم من كميات المبالغ "الضخمة" التي دفعت رشاوى للسلطات العثمانية للحصول على إذن بالحفر، تحت المسجد الأقصى، سرعان ما انكشفت الغاية من الحفريات، فأحدث ردّ فعل شعبية، تمثلت بالمظاهرات الحاشدة والدعوات للحفاظ على المسجد الأقصى.
تتابعت الحفريات من دون جدوى، حيث ادّعى، مثلًا فينزجيرالد في العام 1927، بأنه اكتشف بعض الحجارة التي تعود إلى الحقبة "الإسرائيلية القديمة". لكن السيدة كاثلين كينون، وهي عالمة بريطانية، أكدت أن هذه الحجارة تعود إلى العصر اليوناني. كما نقضت، من خلال التنقيب في مدينة القدس، جميع الفرضيات التي قامت على المدلول التوراتي غير العلمي، نافية أن يكون ما جرى اكتشافه من منشآت هي بقايا هيكل سليمان.
إن الحفريات التي جرت منذ العام 1968 ولغاية العام 1977، مرّت بتسع مراحل، بهدف النيل من المسجد الأقصى، وتسويغ "الوجود الإسرائيلي". وما يعرضه الكتاب، على قدر كبير من الأهمية، لما يكشفه من تفاصيل تدحض المزاعم الصهيونية؛ أي أن بعض العلماء من الغرب والصهاينة حاولوا تجسيد التاريخ، من خلال تزويره، لدواع سياسية وإيديولوجية واضحة.
تصورات وهمية
توسّعت مجالات الحفريات بدءًا من العام 2003/2004، وفي أكثر من موقع في مدينة القدس، سواء في مدينة داود وحي وادي الحلوة ومدينة الواد، وداخل أنفاق حائط المبكى. وأثبتت جميع هذه الحفريات، وعلى مدار القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين، أن محاولة التنقيب هدفت إلى ربط مدينة القدس بالروايات التوراتية، مع أنها تصورات وهمية. ويبدو أن هذا الوهم الذي عاشه بعض علماء الغرب والكيان الصهيوني، كان من الدوافع الأساسية لإبادة ما يمكن إبادته في فلسطين من حجر وبشر.
سكان القدس
بيّنت المسوح الأثرية والحفريات أن "الإنسان وجد في فلسطين منذ أقدم العصور، وأنه عاصر النماذج البشرية". فمنذ المليون ونصف المليون سنة عاش في فلسطين "الانسان المنتصب القامة"، وكانت فلسطين مكانًا للاستقرار والسكن. وعُثر في منطقة "الشيخ جراح"، على عدد من الأدوات الصوانية المؤرخة لهذه الحقبة التاريخية، وعلى بعض الآلات من "العصر الآشولي"، كما عُثر عليها في مناطق أخرى من فلسطين.
ويبدو أن أول من سكن القدس هي "قبائل بدائية في العصر الحجري القديم"، وفي كل بقعة تاريخية كانت الحياة تأخذ أشكالها المتناغمة معها، سواء في اكتساب المعيشة أو في صناعة الأدوات اللازمة لتوفير متطلبات البقاء، بمظاهرها الحضارية كافة، من الحضارة الكبارية (نسبة إلى مغارة كبارة)، والناطروفية (نسبة إلى وادي النطوف)، والطاحونية (نسبة إلى وادي الطاحون في جبال القدس)، وصولًا إلى العصر الحجري النحاسي، وما تضمنه من أدوات صوانية وأوان فخارية، والعصر البرونزي المبكر، حيث أصبح المعدن يُستعمل بكميات أكبر في الأدوات المختلفة، مثل السيوف والخناجر ورؤوس الرماح... مع أن تعبير البرونز لم يكن دقيقًا، لأن السائد كان النحاس وليس البرونز.
لا يعرف أحد شيئًا عن الأوائل الذين استقروا في التلال والوديان، والتي أصبحت تُعرف بمدينة القدس. بالرغم من وجود بعض الأواني الفخارية، في بعض المقابر التي تعود إلى العام 3200 ق.م. غير أنه من الواضح أن المنطقة كانت مأهولة، في العصر البرونزي المبكر الأول. ويبدو أن السكان كانوا شبه بدو؛ لأن ما اكتُشف من أوانٍ فخارية، لم تكن مصنوعة محليًا، بل متواجدة في عدة أماكن في فلسطين. والقدس في العصر البرونزي المتوسط، لم تكن مساحتها تزيد عن أربع آلاف هكتار ونصف، وتقع على ذروة جبل أوفيل، أسفل الجدار الجنوبي للحرم الشريف، وعدد سكانها نحو الألفي نسمة، ومهمة المدينة، أو في جزء منها، على الأقل، التخزين أو مركز للسوق. ويُوضّح، أن علماء الآثار لم يكتشفوا إي أوان فخرية ترجع إلى الحقبة الممتدة من القرن السابع عشر إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد. في المقابل؛ الباحثة كاثلين كينوى اكتشفت ما يُشير إلى أن تاريخ المدينة يعود إلى القرن الرابع عشر – الثالث عشر ق.م.
اختلاق "أورشليم"
في السياق الذي يحاول فيه بعض العلماء مصادرة التاريخ وتزيف الوقائع، يبرز تعبير "أورشاليم" نوعًا من الإختلاق. حيث إن العالم الإلماني "شيث" مثلًا، لفت نظره في عدد من هذه الرسائل كلمة "أوشام"/ "أوشاميم" ففسرها بأنها "أورشاليم"، ومن الجدير الإشارة إلى أن "نصوص اللعن المصرية"، وهي نصوص تُعد من أعمال السحر، ما بين 1850 و1750 ق.م. لكن هذه القراءة أثارت لغطًا، ولقيت معارضة من الباحث "الإسرائيلي" ناداف نعمان، بينما وافق عليها آخرون. وهنا يتساءل المؤلف: هل يمكن لغويًا اعتماد هذه القراءة؟ وللإجابة يقوم بتحليل لغوي استنادًا إلى محمد بهجت قبيسي، إن هذه القراءة غير دقيقة. وتاليًا، لم تعرف "نصوص اللعنات" مدينة تُسمى "أورشليم".
كما أن رسائل "تل العمارنة"، في القرن الرابع عشر ق.م. والتي يبدو تفسيرها وترجمتها صعبة، اعتمدت المصادر التوراتية مرجعًا لترجمة وقراءة هذه الرسائل، بالرغم من عدم دقة هذا المنحى. ذلك؛ لأن تأليف الرسائل موغل في القِدم، ما يجعل إدراج كلمة "أورشليم" فيه نوع من الاختلاق الواضح والصريح. لذلك يوجد شك في ورود اسم "أورشاليم". ولتوخي الدقة والموضوعية، وحتى لا يأتي رأي المؤلف منحازًا، هو يدعو إلى العودة إلى "النصوص الأصلية" لهذه الرسائل، وليس إلى ما كتبه وتناقله بعض المؤرخين الغربيين.
استمرار الادّعاءات
لم يكتفِ بعض المؤرخين بإطلاق الأحكام على عواهلها، بل عمد العديد من المؤرخين التوارتيين إلى القول إن "مولد إسرائيل" يرجع إلى موجة الاستيطان في المرتفعات الوسطى في بلاد فلسطين. غير أن هذه الموجة كانت في الأساس ردّ فعل على الخلل الذي طرأ على الحياة الاقتصادية وتحولاتها الطبيعية. وهذا ما يتجاهله هؤلاء المؤرخين وعلماء الآثار التوراتيين. من هنا؛ وقع هؤلاء في خطأ منهجي عندما نسبوا "مجمل الحضارة المادية للعصر الحديدي المبكر، إلى القبائل "الإسرائيلية"، واسموها إسرائيل"، اعتمادًا على النصوص التوراتية وليس على اكتشافات أثرية تاريخية موثوقة.
إن التوزيع السكني والتطور العمراني، سواء في مناطق جنوبي بلاد الشام ووادي الأردن ومنطقة الجبال الغربية والشرقية، يجعل من الاستحالة من الناحية الإثنية إعادتها إلى "الإسرائيليين الأوائل"، ومن دون توفر أي برهان علمي موثوق؛ خاصة وأن هذه المقولات والمزاعم تعتمد على "مفاهيم توراتية"، لا علاقة لها بالمصادر التاريخية، ولا بالشواهد الأثرية. من هنا؛ يستعرض المؤلف مسار هذه التحولات ليُبيّن أنها عملية "تواصل لا تفاصل" ثقافي، الأمر الذي يدحض المزاعم "الإسرائيلية" المعتمدة أصلًا على "ماضٍ متخيّل"، لأسباب وحاجات سياسية تخدم الكيان الاسرائيلي، ولإيجاد مسوّغ تاريخي لها من جهة، ولطمس التاريخ الفلسطيني من جهة ثانية.
القدس في العصر الحديدي
يَعمد المؤلف إلى استعراض المزاعم التقليدية "التوراتية" عن "أورشاليم" القدس، ويكشف عدم صحتها استنادًا إلى ما كشفه بعض المؤرخين والعلماء، منهم كينون وشيلوه، وغيرهما. إذ أكدوا أن الآثار المكتشفة لا تؤكد الانطباع الذي حاول "التوراتيون" تأكيده. كما أن عالم الآثار"ديفيد أوسّيشكين"، في جامعة تل أبيب، يذهب إلى أن العمل الميداني في القدس لم يؤكد مقولة "الكتاب المقدس". ويستعرض المؤلف آراء بعض الآثار المكتشفة ليوضح أن "أورشليم" كانت بلدة متواضعة جدًا، ومن المستبعد أن تكون "عاصمة لدولة كبرى"، كتلك الموصوفة في النص التوراتي "مملكة إسرائيل الموحدة". والتطور اللاحق، خلال هذا العصر، ترافق مع تطور التبادل التجاري مع المحيط من سورية وبلاد ما بين النهرين وشرق الأردن واليونان وقبرص. وتاليًا، لا وجود لبلدة واسعة وقوية في القدس بحسب هذه المزاعم.
مملكة على الورق
هنا؛ يدخل النص في مسألة على قدر كبير من الأهمية، إذا لم نقل الخطورة، تتعلق بدولة داود وابنه سليمان. ينطلق هذا الكتاب من أن إعلان "دولة إسرائيل" الحديثة، والذي صدر في تل أبيب بتاريخ 14/5/1948، يشير إلى "إعادة بناء الدولة اليهودية". وفي هذا إشارة إلى أن "جذور" هذه الدولة تعود إلى "دولة العصر الحجري". بالرغم من أن هذا الإعلان هو، عمليًا، صياغة لإعلان بلفور الذي تحدث عن "إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين". وإن الباحثين التوراتيين، وكذلك بعض علماء الآثار، تصوروا وجود مملكة في العصور الغابرة، "العصر الحجري"، كان قد أسسها داود وابنه سليمان كونهما يُشكلان في التوراة، مرتكزًا وأساسًا للمزاعم الصهيونية، وأنهما "جِد للصهيونية المعاصرة". هذا الوهم المزعوم هيمن على الدرراسات التوراتية، في هذا القرن، وأسهم في "إهمال الشعب الفلسطيني وتحقير ثقافته". كما أغفل التاريخ الفلسطيني كليًا.
وعليه؛ يُقدم الكتاب آراء مؤرخين وباحثين لتوضيح كيف سعى اللاهوتيون إلى إثبات "التصورات الأمريكية لفلسطين في العصر الأول من الانتداب" وفقًا وانسجامًا مع ما هو مصور في التوراة، الأمر الذي أسهم في التوهم بأن فلسطين "وطن قومي يهودي" وإلى أنها "أرض يهودية"، استنادًا إلى مغالاة في موضوع "المملكة الداودية – السليمانية". لكن حتى اللحظة، لم يتمكن الآثاريون التوراتيون أو الأمريكيون من العثور على أي دليل يُشير صراحة أو كتابة إلى وجود هذه المملكة في فلسطين. لدرجة أن عالم الآثار أمنون بن ثور، في الجامعة العبرية، يرى أن "المسألة تشبه نقطة زيت تسقط فجأة، قد نجدها في كل مكان إلا هنا".
لذلك؛ يُقدم المؤلف آراء تؤكد الشكوك حول هذه المملكة. فالباحث ليتش اعترف أنه لا يصدق هذه القصص، ولولا قداستها، لكان وجودهما (داود وسليمان) مرفوضًا بالتأكيد. كما أن العديد من الباحثين يذهبون إلى غياب أي دليل على وجود هذه المملكة. وقد رأى عالم الآثار "الإسرائيلي زئيف هيرزوغ" أن التنقيب في القدس، وعلى امتداد الـ 150 السنة الماضية، لم يكشف وجود أي آثار لبناء يعود إلى حقبة هذه المملكة، وأن "أورشليم" في زمن داود وسليمان، كانت مدينة صغيرة، وربما قلعة صغيرة، ولم تكن عاصمة لإمبراطورية، كما تصفها التوراة. بمعنى آخر هي ليست إلا "اختلاق حذلقة تاريخية". وقد شكك عالم الآثار الإسرائيلي "يسرائيل فنكلشتاين"، من جامعة "تل أبيب"، بوجود أي صلة لليهود بالقدس، وإن كل ما يقال هو مجرد وهم وخيال. وهذا يعني، أن المملكة الداودية السليمانية ليست أكثر من "اختراع توراتي" تنفيه كل الوقائع والأركيولوجية والتاريخية في بلادنا فلسطين.
هيكل سليمان
في السياق ذاته، يشير، الكتاب إلى أن القول بوجود هيكل سليمان أو معبد القدس أو المعبد اليهودي الذي بناه سليمان، في القرن العاشر قبل الميلاد (بيت همقداش)، ليس له أي مصدر تاريخي. لكن المصدر الوحيد الموجود لهذه الفرضية/القول هو العهد القديم والعهد الجديد. من هنا؛ يعرض الكتاب النص الحرفي للتوراة، بحسب ما ورد في الكتاب المقدس، في "سفر صموئيل الثِّاني" و"سفر أخبار الأيام الأوَّل" و"سفر الملوك الأول". ويذكر المؤلف أن بعض العلماء والفلاسفة في القرن الثامن عشر، ومنهم إسحق نيوتن، اقتنعوا بفكرة الهيكل، في سياق إيجاد "تفسيرات علمية خاصة لإعادة اليهود إلى فلسطين".
في هذا السياق؛ يُشير المؤلف إلى أمرين للدلالة على أن فكرة الهيكل كانت اختلاقًا وخيالًا، وهما على النحو الآتي:
الأول، يستند إلى الكتاب المقدس الذي يتضمن تناقضًا في التفاصيل التي أوردها، لجهة حجم المعبد، طولاً وعرضًا وارتفاعًا في "سفر الملوك الأول" و"سفر أخبار الأيام الثّاني". هذا التناقض يُعزّز الشك في وجود الهيكل.
الثاني، يستند إلى آراء علماء آثار، ومنهم أوسَشكين، أستاذ الآثار في جامعة تل أبيب والأستاذة جين كاهل من الجامعة العبرية، واللذان يؤكدان عدم وجود دلائل أو بقايا أثرية في القدس، يمكن الاستناد إليها لتأكيد وجود هكذا بناء. والموجود، برأي البعض، هو عبارة عن قصة، الأمر الذي لا يُشجع على معاملتها، كما لو أنها حقائق تاريخية.
إزاء هذا، يغدو التساؤل مشروعًا، لماذا فشلت المساعي الصهيونية بإيجاد دليل أثري واحد يُثبت وجود هيكل سليمان أسفل الحرم الشريف في القدس، وبالتحديد تحت المسجد الأقصى؟ مبسوّغ هذا التساؤل، يعود إلى أن أرض فلسطين وجد فيها العديد من الآثار، تعود إلى العصور الحجرية القديمة وإلى مليون وسبعمئة وخمسين ألف سنة. والجواب، بالنسبة إلى المؤلف واضح جدًا؛ لأن القصة غير قابلة للتصديق، وهي فكرة متخيلة واختلاق توراتي.
بناء على ما تقدم، ملوك "بني إسرائيل"، في فلسطين، ليسوا إلا أشباحًا وكائنات خرافية اخترعها "الكتاب المقدس". وتاليًا، الحروب باتجاه القدس (حروب: شيشناق المصري، وسنخاريب الآشوري، ونبوخذ نصر البابلي) لا تخدم المزاعم اليهودية، كما بينت الوقائع التاريخية والمكتشافات الآثرية، ويدحض فكرة أن غزوة نبوخذ نصر و"السبي اليهودي" حدثا في بلادنا فلسطين.
لوثة مرضية
إن السعي اليهودي للتدليل على وجود الهيكل المزعوم تدحضه مجموعة من الأثريات، والتي ثبت زيفها، بحسب علماء غربيين و"إسرائيليين"، منها على سبيل المثال، ما عُرف بـ "الرمانة العاجية" التي روّج لها العالم الفرنسي أندريه لومييه، وثبت زيفها باعتراف علماء يهود. ومنها نقش "تل القاضي" الذي اكتُشف العام 1993، وأثارت جدلًا، ليتبن أنها غير صحيحة تاريخيًا. ونقش "يهواش" الذي أعلن عنه العام 2003، بفعل "المسح الجيولوجي الإسرائيلي"، غير أن خبير اللغات الساميّة، في جامعة "تل أبيب"، إد. غرينشتاين، أوضح مع غيره، أن الاستعمالات اللغوية في النقش لا تنتمي إلى عبرية القرن التاسع عشر ق. م. كما بيّن زيفه وعدم صحته التاريخية، وكذلك أكد آخرون من جامعة حيفا وجامعة "تل أبيب". ولمزيد من التأكيد، يشير المؤلف إلى أن سلطة الآثار "الإسرائيلية" اضطرت لتشكيل لجنتين لتصل إلى النتيجة الآتية: أن هذا الأثر مزيف.
كذلك نقش "السلوان" الذي عثر عليه، في العام 1880، وأحدث نقاشًا حول تاريخه، إلى أن أكدت مجلة علمية أمريكية في مقال بقلم عالمين، من جامعة شيفلو في إنكلترا، أن هذا النقش يرجع إلى القرن الثاني أو الثالث ق.م. وليس إلى القرن الثامن ق.م.. وهذا الرأي له تبعاته المهمة المتعلقة بتأكيد عدم صحة المزاعم "الإسرائيلية". وتاليًا لم تستطع مسارات التنقيب الصهيوني الوصول إلى أي نيبجة إيجابية لدعم ادعاءاتها.
في السياق ذاته؛ "بردية يروشالمه" المكتشفة في العام 2016، حيث تدعي "سلطة الآثار الإسرائيلية" أنها ترجع إلى القرن السابع ق.م، وعليها كتابة بالعبرية "يروشالمِه". وهذا برأيهم الاسم العبري الأصلي لمدينة القدس. واستغلها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ليُحاجج الأمم المتحدة بأن القدس عبرية وليست عربية، أو آرامية ولا يونانية، ولا لاتينية، غير أن فحص هذه البردى، لم يكن حتى الآن، دليلًا لإثبات صحتها.
الاحتلال الفارسي وخدعة العودة
حكم الفرس المنطقة حوالي مئتي عام، ولم يذكروا معلومات مهمة حول بلاد الشا، في الوثائق الصادرة عنهم. لكن هيرودوت اليوناني ذكر فلسطين والفلسطينيين ومشاركة سكان فلسطين في حروب الفرس. غير أن ما جاء في "سفري عزرا ونحميا" في الكتاب المقدس، حول السماح بعودة "سبي اليهود"، لا وجود لأدلة أثرية تؤكده، حتى الآن. وهذا ما دفع رئيس دائرة الدراسات السامية في جامعة كامين، في هولندا، للقول: إن "عزرا شخص وهمي". وهذا ما ذهب إليه الأستاذان، في الدراسات الكتابية في جامعة شفليد في بريطانيا، بأن شخصية عزرا قد تكون اختلاقًا أدبيًا؛ بل أنهما غير مقتنعين بحكاية "العودة من المنفى" التي تحتل فيها عملية بناء "الهيكل الثاني" مكان الصدارة.
كما أن كتاب "تاريخ هيرودوت"، لم يشِر، ولو تلميحًا، إلى "يهوذا" و"إسرائيل". لذلك لا تُذكر في "سفر عزرا" ولا تقدمها أي وثيقة فارسية. وتاليًا، لو افترضنا افتراضًا فقط، أن العودة اليهودية تمت، فــــــ"إعادة الإستيطان" لم تترك أي أثر ديمغرافي مرئي للسكان، ولم تترك أي بصمة في الدليل الأثري. لذلك ليس هناك أي دليل بتمييز "أورشليم القدس" على أنها "مدينة مقدسة في الحقبة الفارسية.
عود على بدء
إن الكتاب، موضوع المراجعة، يؤكد أن القدس القديمة كانت مجالًا للتواجد الإنساني، منذ أقدم العصور. ويُبيّن، بحسب المكتشافات، أن سكانها حملوا صفات البحر المتوسط وأن أصولهم سامية، أو بالأصح جزرية (نسبة إلى الجزيرة العربية). وقد أُطلق على سكان فلسطين ولبنان وسوريا، منذ القِدم، تسمية كنعان، وكنعانيون، مع كل ما يحمله تعبير "الكنعانيين" من نقاش؛ مُشيرًا، إلى أن اليونانيين تحدثوا عن الفينيقيين، ولم يذكروا الكنعانيين.
وعليه؛ يرى المؤلف أن هذا الكتاب "نقطة البداية" لإعادة كتابة تاريخ القدس واكتشافها، بعد تحرير الحقائق التاريخية المتعلقة بتاريخ فلسطين، من ماضٍ خيالي وهمي، فُرّض علينا بواسطة خطاب الدراسات التوراتية.
غزة تتمة
انطلاقًا من هذا الكتاب، يمكن بكل سهولة معرفة ماذا يجري اليوم في قطاع غزة من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، بدعم العالم الغربي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية. إن الفشل الصهيوني، والمدعوم عالميًا، لم يستطع "إثبات" أي دليل علمي تاريخي، تدعمه الوثائق التاريخية والاكتشافات الأثرية، بأي حق له في أرضنا فلسطين. ومع كل سياسات الاحتلال والتهجير والقمع والطرد والإبادة؛ بقي الشعب الفلسطيني ثابتًا صامدًا مقاومًا، بإرادته وقوة إيمانه بأرضه وحقه من جهة، وبتجذر تاريخه الضارب في عمق التاريخ من جهة ثانية.
لذلك؛ يمكن النظر إلى أهمية هذا الكتاب وضرورته، خاصة في هذه اللحظة السياسية التي يتعرض فيها شعب فلسطين في قطاع غزة للإبادة الجماعية. الأمر الذي يدفع للقول، ومن دون أي تردد، أننا بحاجة ماسة إلى مثل هذه الدراسات لمواجهة العدو المحتل ودحض ادعاءاته. ومثل هذه الدراسات، هي بحد ذاتها، سلاح يستند إلى العلم والمعرفة لمقاومة العدو. كما يواجه أهلنا في فلسطين الجرائم اليومية التي يرتكبها الصهاينة لإبادة "شعب الجبارين"، وتسويغ احتلالهم.
وعليه، حرب الإبادة الجماعية بحق أهلنا في قطاع غزة، اليوم، يأتي في السياق السياسي التاريخي الذي اعتمدته الحركة الصهيونية مع تاريخ فلسطين؛ لأن الاحتلال الصهيوني الذي لم ينجح في تأكيد ما يراهه "حقه"، بالرغم من كل التزوير والتشويه التاريخي، يحاول، اليوم، إبادة الشعب الفلسطيني والقضاء عليه، لإثبات هذا الحق المزعوم والمتخيّل. إنها معركة وجود، وثمنها سيكون باهظًا، خاصة أن "الدول الحضارية" الداعمة والمساندة للعدو الصهيوني هي خارج المنطق الإنساني وشرائع العدل والاتفاقيات الدولية.
إقرأ المزيد في: قضايا وكتب
26/03/2025
"الروح المجرد" : أحوال أهل التوحيد والعرفان
13/08/2024
قراءة في كتاب : بيادر التعب (2/2)
07/08/2024
قراءة في كتاب : بيادر التعب (2/1)
التغطية الإخبارية
لبنان| المفتي قبلان: ما نريده دولة تشبه شعبها وتدعمه
لبنان| المفتي قبلان: الخارج وحش مجرم ولعنة الخارج ما زالت تلازم لبنان ولا مكان للعواطف في خرائط الخارج
إيران| الإمام الخامنئي يأم صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العاصمة طهران
لبنان| المفتي قبلان: من يمنع الإعمار ومن يخنقنا ويتركنا بالعراء يساهم في أخطر حرب علينا
لبنان| المفتي قبلان: الخطأ بموضوع سلاح المقاومة أكبر من لبنان والمنطقة
مقالات مرتبطة

الشيخ قاسم: إذا لم تلتزم "إسرائيل" فلن يكون أمامنا إلا العودة إلى خيارات أخرى

إحياءً ليوم القدس العالمي.. فعاليات شمالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني

فيديو| إحياء يوم القدس العالمي في العاصمة العراقية بغداد

بالصور| الهيئات النسائية تحيي يوم القدس العالمي في البقاع الغربي وقرى قضاء صيدا

رابطة علماء اليمن: فلسطين أمانة الله في أعناق المسلمين ولا حق لليهود فيها ولا شرعية لوجودهم على ترابها

الأديب الراحل جورج شكّور.. إرثٌ خالدٌ في عالم الثقافة

المقاومة تمثل قمة التاج في ثقافة الحياة

القائد الأديب.. احتضانٌ للثقافة والمُطالعة

قراءة في كتاب: "الفرعون والقسّيس"