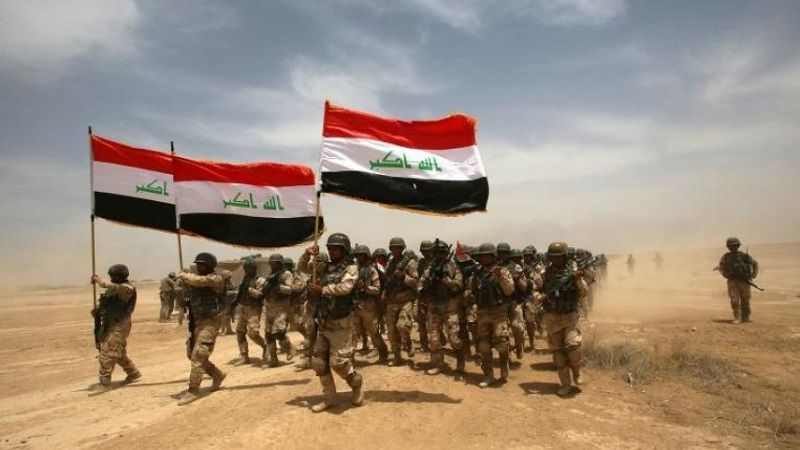آراء وتحليلات
"الدفاع المقدس" بين الفرص والأزمات
أحمد فؤاد
خلال كلمة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي في أسبوع الدفاع المقدس بالجمهورية الإسلامية، اختصر كل ما يمكن من معانٍ بليغة وشواهد بالغة الدلالة، في جملة واحدة بخطابه، قال فيها إن "قوة الثورة وقدرتها وقيادتها، وخصوصيات شعبنا، استطاعت ان تحول الحرب إلى فرصة كبيرة".
وما أحوجنا كعرب، شعوبًا ومسؤولين، إلى إعادة دراسة واستذكار السنوات الأولى من عمر الثورة الإسلامية في طهران، ليس بحثًا عن حكايا المقاومة التي تبعث الأمل وتبث الإيمان في القلوب، ولا استظهارًا لحفظ وترتيب حوادث إيران والمنطقة في هذه السنوات التي شهدت أعنف التغييرات على وجه المنطقة، لكن للتمكن من قراءة تجربة حية، استطاعت -ولا تزال- مجابهة التدخل الأميركي وكسر أدوات الغرب، والخروج تمامًا من فلك السيطرة الأجنبية، وتحرير ثرواتها لصالح شعبها وثورتها.
قدمت الثورة الإسلامية إجابة السؤال الوجودي للشعوب العربية، وهو سؤال الصمود، خلال سنيها الأولى، بالاستعانة أولًا بقدرات الشعب الإيراني الفريدة، ومخزونه الحضاري الضارب في القدم، واستمرار وجوده الإنساني على نفس البقعة الجغرافية لعشرات القرون، ومروره بالتجارب والأزمات، وعبوره الأطوار التي مرت بها كل حضارة بشرية من تمدد واسع خارج حدودها أو تراجع فرضته عليها قوى أخرى، وبالتالي كانت الثورة تستند في شعبها اعلى ركن ركين.
وقدمت الثورة الإسلامية إجابة السؤال الملح للشعوب العربية، وهو سؤال التنمية في ظل حصار غربي وأميركي خانق، وحالة من الاستقطاب الطائفي قادتها أنظمة ودول من أدوات الأميركي ضدها، بالاعتماد على تنمية تتمحور أساسًا حول الذات، وتؤمم مصادر ثرواتها لصالح الأمة كلها، ثم تعيد إدارة هذه الثروات والموارد في إطار اقتصاد وطني، يبني فيه الفائض ويوزع، وتنتزع حقها في العيش الكريم، وتقدم المثل على القدرة والثبات، ولا تطلب من الآخرين المساعدة والمواساة، وتخطط لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى عبر خطط فعالة، ترى الواقع ومشاكله، وتتعامل معها وتحلها، دون أن تقفز عليها أو تتجاهلها.
وبهذا كله كانت الثورة تقدم الخطاب العملي الواقعي، لا المثالي، لكل الأزمات التي تعترض طريق أية أمة ناهضة، ومهما بلغت درجة العزلة أو العداء الغربي لها، فإنها استطاعت تحويل التحدي إلى فرصة، والاستغناء عن نمط العيش والحكم الغربي، لصالح نمط وطني، يضع السلطة في مقدمة الأمة على طريق الاستجابة للتطلعات والأماني الطبيعية لشعبها، وهي بالتالي وضعت المجتمع كله في خندق واحد، تنصهر فيه الفردانية لصالح المجموع، وتتوحد فيه المطالب بين الحكومة والمحكومين.
صنعت الثورة قاعدتها الوطنية الصناعية الهائلة، لتصبح بعد عقود قليلة ضمن الأفضل في العالم الثالث، بصناعات متطورة مدنية وعسكرية، وحتى فضائية، قائمة على قاعدة من العلماء والفنيين المحليين، وفرت لهم الدولة العلم وقدموا لها الذخيرة في سنوات المواجهة والحصار، وعلى قطاع زراعي يكفل تلبية الغذاء دون التورط في فخ الارتهان للسوق العالمية، وهي في هذا كله كانت تقدم المثل والإلهام والإجابات، لشعوب فضلت الوصفة الأميركية للتقدم، فسقطت في أسر التبعية المقيت.
الغريب أن عام قيام الثورة الإسلامية، بكل أحداثها وتداعياتها المحلية والإقليمية والعالمية، قد شهد بداية ميلاد ملامح الحاضر العربي، الذي نعايشه اليوم مرارة وإحباطًا، فمن التوقيع المصري النهائي على معاهدة الاستسلام للعدو الصهيوني والارتماء تحت أقدام الصديق الأميركي، وخروج أكبر دولة عربية بالتالي من معادلة الصراع العربي الصهيوني، إلى حادثة اقتحام الحرم المكي، بواسطة مجموعة جهيمان العتيبي، والتي استعان فيها آل سعود بالقوات الفرنسية تضرب الحرم وتحافظ على استقرار النظام المسيطر في السعودية، والتي ما لبثوا أن كرروها ضد حليفهم السابق صدام حسين باستدعاء الجيوش الأميركية لطرده من الكويت، كان النظام الرسمي العربي يكشف عداءه السافر ضد التطلعات الوطنية ويبدد كل أوراق القوة والفعل من بين يديه.
وفيما كانت الدول العربية في نفس الفترة، بقيادة شيوخ قبائلها وأمراء حروبها، صدام والسادات وسواهما، يخوضون الصراعات ضد أمتهم وشعوبهم لإثبات الولاء المطلق للأميركي، والحصول على حق وكالته في المنطقة، كان السيد الأميركي يداعب خيال الكل، ويحصل منهم على كل ما قد يرغب به، ثم يتخلص منهم عقب انتهاء مهماتهم في أقرب سلة نفايات، ثم يجتهد في هندسة أتباعه بالمنطقة على مقاس الوكيل الصهيوني الحصري.
ولعل أهم ما يمكن اكتشافه في قصة الثورة الإيرانية، هو إعادة قراءة القانون الأول من قوانين الحركة العالمية والصراع بين الأمم، والذي يقول إنه حين يرضى طرف ما لنفسه أن يستجدي، فإن الطرف الآخر مدعو لأن يستقوي ويتشدد، فالغاية النبيلة والمواقف الشجاعة لا تحركها وسائل ذليلة، ولا يصلح لها الانبهار بالآخر والانسحاق أمام ثقافته والخشوع أمام رموزه والتماهي مع إرادته ومخططاته، والارتعاد فور رؤية مدافعه وصواريخ بوارجه، وأن التراجع في خضم صراع مع قوة عالمية أو إقليمة لا يولد إلا مزيدًا من التراجع، وبقدر ما تقدم دولة على التراجع فإن عدوها قد كسب مقدمًا أرضًا مجانية، ومساحة جديدة لنفوذه، لن تجعله قانعًا، بل ستزيد مطامعه.
لا تسلم القوى المسيطرة بالحقوق المشروعة ولا الأماني الوطنية، مهما بلغت الشعوب من قدرات على إثباتها أو حشد التأييد العالمي لها، لكنها تسلم أمام ما تراه من قوة وتخشاه من رد فعل الأمة إن هي تجرأت على تجاوز حدودها أو الاستيلاء على ما ليس لها، القوة وحدها وقبل الحق هي المفردة الوحيدة المفهومة في الصراع العالمي على الثروات والمقدرات، وحدها قادرة على الردع ووحدها تستطيع استرداد الحق السليب.
إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات
23/11/2024
لماذا تعرقل واشنطن و"تل أبيب" تسليح العراق؟
21/11/2024