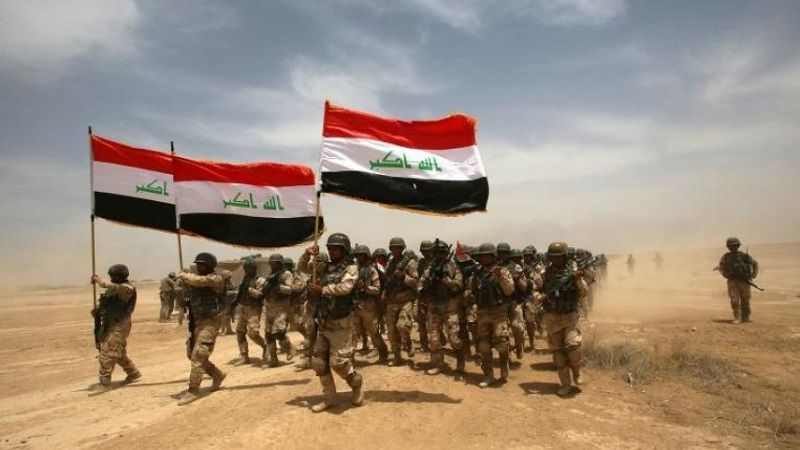آراء وتحليلات
الدولة والوطن.. يوم رحل إدريس بطل أكتوبر
أحمد فؤاد
تخلط التعريفات القانونية والدستورية بين مفهومي الدولة والوطن، بشكل مربك، يضع مؤسسات الحكم وسلطاته أحيانًا موضع القداسة الموجهة أصلًا للوطن، ككيان فوق كل تعريف أو توصيف، يربط الإنسان بأمته، وأرضه، يجد فيه الإنسان الحلم أحيانًا، لكنه دائمًا ما يبعث الشعور بالحب والانتماء.
التمييع، وتشويش الرؤية، وبالنهاية تحويل البوصلة الوطنية عن قضايانا وقضايا أمتنا وتحدياتها، هي أحد أبرز مظاهر ما يجري في عدة دول عربية. تهدد دائمًا دماءنا السيالة في مواجهة العدو الصهيوني خطط الحكام لفرض القبول المعنوي لوجوده، ومنحه صك الولوج إلى شوارعنا، وصولًا لأن يصبح أقرب إلينا من أشقائنا العرب، لكن هيهات، في كل ذكرى وطنية ستظل تضحيات المصري العادي تصفعهم، وتركل أصحاب ذاكرة السمك، وتزيد من ارتفاع الحاجز الأزلي بينا وبين أصدقائهم في "تل أبيب".
الوطن هو المقدس كله، الأرض والشعب، الماضي والحاضر والمستقبل، ولو نزعت ورقة الوطنية من النظم التي تظل حريصة على تغطية كل تصرفاتها بها، فإن استمرارها يوما واحدا بعد في الحكم سيكون أضغاث أحلام، وفي مصر مثلًا، فالنظام الحاكم يحاول تغطية كل عوراته بصبغة الوطنية، لإقناع الأغلبية بأنه يعمل لصالحهم، أو أن ضررهم المؤقت لصالح وطنهم، وهو كذوب بالتأكيد، لكن لا ينفي فكرة القداسة عن الوطن على الإطلاق.
لذا كان مفهومًا أن ينزوي الحديث في مصر عن رحيل أحد أبرز أبطال حرب أكتوبر، المواطن العادي أحمد إدريس، لصالح وفاة أحد رموز الدولة، ووجوهها، قائد الجيش الأسبق ورئيس المجلس العسكري الذي تولى الحكم في أيام عاصفة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، والذي حظي خبر وفاته، ثم جنازته العسكرية بالتغطية الهادرة للإعلام.
الحقيقة أن كلا الراحلين شارك في حرب أكتوبر، لكن المواطن النوبي العادي أحمد إدريس ظل واحدًا من بين عشرات الألوف ممن قدموا وضحوا ومكنوا الجيش المصري من عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف، لكنه ظل على الهامش، وظلت حكايته في بند الأسرار العسكرية لمدة 44 عامًا، حتى تم تكريمه أخيرًا، ولحسن حظنا نحن، في 2017.
بطولة إدريس تلخص في بساطة وعمق شديدين قصة الخلاف في مصر، بين دولة نسيت أو تناست أدوارها، ومواطنين سافروا إلى المستحيل لصنع الانتصار، الذي كاد يكون كاملًا لولا تدخل السادات والذين معه، في مسار الحرب أولًا، ليحولوها إلى كارثة، ثم في المسار الاستسلامي بعدها، ليحولوا الوضع العربي كله إلى نكبة جديدة، توازي نكبة 1948.
إلى بداية الحكاية، في سنوات اللاسلم واللاحرب، التي أعقبت رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، في مثل تلك الأيام من شهر أيلول/ سبتمبر 1970، وتلكؤ خلفه أنور السادات في اتخاذ قرار الحرب، وعبثه بالقيادات العسكرية بالسجن (في حال الفريق محمد فوزي 1971)، أو الاستبعاد (كما حدث مع محمد صادق 1972)، وحرصه على منح كل من يقترب منه انطباعًا بالعجز عن اتخاذ قرار الحرب، لضعف أو قدم التسليح السوفييتي، والذي كان في تلك السنوات نفسها، وفي أيدي الفيتكونغ في فيتنام، يتفوق على السلاح الأميركي وفي أيدي صانعيه أنفسهم.
دخل أحمد إدريس الجيش المصري كجندي متطوع، سيرًا على درب أبائه وأجداده، حين كانت الإمبراطورية المصرية القديمة تضم فرقة "الميدجاي" الأقوى بين فرق الجيش المصري، رماة ومقاتلين من شعب النوبة فقط، واشتهرت الفرقة ببطولتها في حروب مصر القديمة ضد الهكسوس، ثم في قارة آسيا، وتحولت الفرقة لاحقًا إلى مجموعة مقاتلة نخبوية تحمي المدن المهمة والمعابد والقصور الملكية.
من التاريخ جاء، وإلى المستقبل نظر، وعلا على الحاضر إلى مجد رآه مشيدا بعينيه، وقت أن كانت أزمة الساعة في الجيش المصري هي اختراق الصهاينة للشبكات العسكرية المصرية كافة، ومعرفتهم بكل الأوامر الصادرة من وإلى المجموعات المقاتلة، وكسر كل محاولات التشفير المصرية البائسة.
وصل إدريس إلى قائد تشكيله القتالي، والذي كان يبحث في سؤال وجهته القيادة لعدد من ضباطها عن طريقة لنقل الرسائل والأوامر بشكل يصعب على العدو تتبعه، ليخرج العبقري بحله البسيط العظيم، بتولي النوبيين مهمة نقل الرسائل عبر أجهزة الإشارة بين قيادة الجيش والوحدات المنتشرة على طول القناة، باللغة النوبية، ولأنها غير مكتوبة، فسيكون من المستحيل على الصهاينة فكها أو فهمها من الأصل.
فورًا تبنى الجيش الفكرة، وتم تعميمها وسط ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة في سرية كاملة، وبانتظار ساعة الصفر، وهو ما حدث وأربك الخطط الصهيونية لفترة، جعلت من العبور ممكنًا، ومن التمسك برؤوس الجسور على قناة السويس رهنًا بإرادة الجندي المصري العربي، الذي أثبت أنه الأقدر على مواجهة وقهر العدو الصهيوني، حتى في ظل غياب الإمكانيات، وأنه لا يقل ذكاءً عن نظيره، والذي لا يعتقد بتفوقه عليهم سوى حكامنا البؤساء.
وفي ظل حكم طبقة كامب ديفيد، جيلًا بعد جيل، سقط أحمد إدريس من حسابات التكريم، رغم تكريم ألوف ممن لم يقدم الواحد منهم ما يوازي الفكرة العبقرية للمقاتل العبقري الأسمر، وفي النهاية جرى تكريمه بوسام عسكري، بحجة أن ما فعله كان يعتبر أسرارًا عسكرية!
مع وداع مصر لواحد من أبرز أبطالها، ورجالها، ونابغيها، لا يزال العداء مع الصهيوني هو نبض القلوب وإشارة البوصلة التي لا تكذب ولا تضل، ولا تزال العلاقات مع الكيان ومن والاه ومن راعاه هي السبب الأول للكراهية والعار، في الدنيا والآخرة.
إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات
23/11/2024
لماذا تعرقل واشنطن و"تل أبيب" تسليح العراق؟
21/11/2024