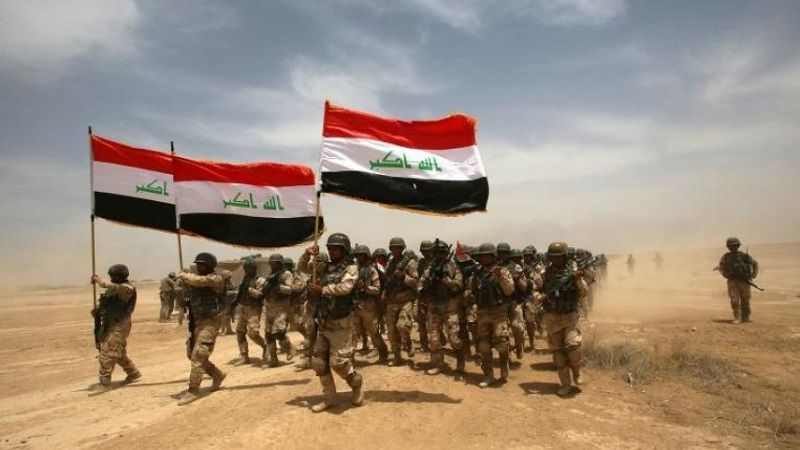آراء وتحليلات
الانكشاف الاستراتيجي في مصر وطرق المواجهة العاجلة
إيهاب شوقي
لعل التحذيرات من تحول التوجهات المصرية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، جاءت مبكرة وانطلقت مع ارهاصات التحول وقبل تدشينه رسميا، ثم استمرت ولا تزال. الا أن التحديات لم تولد استجابة ملائمة، نظرًا لميراث ضخم من فترة التحرر الوطني وفائض قوة ناعمة أجلت الشعور بالأزمة، ناهيك عن اغراءات مكنت للتحولات، وتبع ذلك الوقوع في فخاخ متلاحقة، مما أوصلنا لهذه اللحظات الحرجة والتي تبدو بها مصر محاصرة من كافة الجهات جغرافيا، وتبدو وكأنها ايضًا ضيقت على نفسها الخيارات بشكل طوعي، ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بما يفوق حتى حجم وقوة القيود الخارجية، وهو ما افتقدت معه حتى المناورات وبدت وكأنها عاجزة عن المقاومة، وهو وضع خطير يتطلب علاجًا سريعًا وحاسمًا.
من المؤكد أن خطر سد النهضة الاثيوبي، هو خطر وجودي، ومن الثابت أن لمصر خطوط حمر تتعلق بدول الجوار المباشر، وأن الأوضاع في ليبيا تدخل في النطاق المباشر للامن القومي المصري، الا أن الخطر الأكبر بأتي من الشرق حيث يقبع العدو الاسرائيلي بمشروعه ونظريته للأمن والتي تتعارض قولًا واحدًا مع الأمن القومي العربي وبشكل أعمق مع أمن دول الطوق، وهو المصطلح الذي أطلقه الزعيم جمال عبد الناصر على سوريا ولبنان والاردن ومصر.
والسبب المباشر في ذلك هو أن القيود التي تفرض على هذه الدول منبعها هو (امن "اسرائيل") وتعمل أمريكا على فرض هذا الأمن عبر سياسات تتنوع بين العصا والجزرة، ولكن المفارقة، أنها يمكن أن تصل بالعصا لمداها الأقصى وفقًا لتوازنات الردع، بينما لا يمكن أن تصل بالجزرة لمنتهاها، حيث هناك حدود وأسقف لا يمكن تخطيها في الاغراءات والمكافات بما يتعارض مع الهدف الرئيسي وهو امن العدو الاسرائيلي.
تثيت الاحداث منذ كامب ديفيد والى الان، ان السياسات الامريكية استهدفت احتواء مصر وفصلها عن محيطها العربي والافريقي من حيث القيادة وعن تماسك جبهتها الداخلية عبر سياسات توسيع الفوارق بين الطبقات اقتصاديا، وزرع الفتن ثقافيا وسياسيا.
وليس غريبا هنا تزامن التخلي عن الصراع العربي الصهيوني وتحوله لعملية سلام وصراع فلسطيني - اسرائيلي والتحول من طرف الى وسيط، مع سياسات الانفتاح الاقتصادي والسوق الحر والبدء في تصفية القطاع العام الذي مول الصمود والحروب وشكل السند الاكبر في التمكين من الاستقلال الوطني.
أصبح الاقتصاد فزاعة ومبررا للتخلي عن المقاومة، بحجة عدم القدرة، واستحدثت شماعة التوقيت لتعليق سياسات المهادنة عليها، بحجة أن التوقيت غير ملائم للمواجهة، واستبدل المشروع القومي فأصبح انتظار وترقب التنمية بدلا من التنمية ذاتها!
ولأن الصدام في مرحلة التحرر الوطني والمقاومة كان مع الرجعية العربية باعتبارها مشروعًا عميلًا للاستعمار، فمن الطبيعي أن يصبح الحلفاء اليوم هم أعداء الأمس، ومن الطبيعي أن تقفز الرجعية العربية للقيادة، وأن تنبري لمساعدة مصر في أزماتها لاحتوائها وقطع الطريق على عودة تحالفاتها القديمة مع معسكرها الأصلي المقاوم.
وبالنظر للمساعدات الأمريكية والخليجية، فلا يستطيع أي مدافع عنها أن يدعي أنها ساهمت في مشروعات انتاجية، بل كانت في صور ودائع لانقاذ الاحتياطي النقدي ومواد بترولية وكان معظمها على شكل قروض وقلة منها منح لا ترد، وكلها كانت لأهداف سياسية، إن لم تشكل تبعية تامة للخليج، فهي على أقل التقديرات تضع قيودًا وأسقفًا لا يمكن تخطيها عند التعارض.
نعم كان لمصر سقف في سوريا واليمن، منع مصر من الانخراط التام في السياسات الرعناء المدمرة، وحافظ على حد ادنى من الامن القومي المصري، لكن هذا التحالف الاحتوائي منع مصر من اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الاغلبية الساحقة من عناصر امنها القومي!
يعرف خبراء الامن القومي أن هناك نطاقات للامن، عالمية واقليمية ومباشرة، وهذه النطاقات تضررت جميعها بقيود التحالف مع امريكا والخليج.
فالنطاق العالمي تراجع دور مصر به، بعد فرض القيود الامريكية الهادفة بالاساس الى الهيمنة، وافتقدت قوة مصر العالمية التي اكتسبتها من رعايتها للمستضعفين ومقاومي الهيمنة وحركات التحرر الوطني، واصبحت مجرد (دولة شرق اوسطية) منزوعة القوة ومفتقدة لاوراق الضغط.
وعلى مستوى النطاق الاقليمي، لم تعد مصر قوة اقليمية قائدة، لان الانخراط في المشروع الامريكي الخليجي يضع قيودا على دول الطوق وحلم بن غوريون القديم هو أن يتم عزل مصر خلف حدودها، اضافة الى افتقاد القوة الناعمة عربيا وافريقيا، وترك المجال للعدو الصهيوني يمرح بالقارة وهو ما أدى الى استهانة غير مسبوقة بمصر، لعل الممارسة الاثيوبية تشكل احد تجلياتها من حيث الشكل، رغم وجود أدلة وشواهد على انه من حيث الموضوع، فإن السد هو مشروع امريكي يحركه البنك الدولي بمساهمات من حلفاء مصر الخليجيين وحماية عسكرية من الطرف الاخر في معاهدة السلام المزعوم وهو العدو الاسرائيلي!
والشواهد تقول إن بمصر أكثر من مدرسة مؤثرة على قراراتها، فهناك مدرسة لا تزال تؤمن بالخطوط العريضة للامن القومي وتفرق بين التناقضات الرئيسية والثانوية وتعرف ان العدو في الشرق، وهذه المدرسة موجودة بلا شك داخل المؤسسة العسكرية واجهزة سيادية، وهناك مدرسة تشكلت على وقع لقاءات كامب ديفيد ومعاهدة السلام ونالت تربيتها وتعليمها وفقا لهذا المناخ، وهي منتشرة كثيرا في الدبلوماسية المصرية وقطاعات بيروقراطية اخرى.
هذه الازدواجية أعاقت كثيرًا معالجة العديد من الملفات الحساسة والخطيرة، ومكنت لتحالفات ضارة وأعاقت تحالفات سليمة وطبيعية.
ومن المؤسف كمظهر من مظاهر هذه المفارقات المؤسفة، أن لا تكون هناك علاقة رسمية بين مصر وسوريا رغم محاربة نفس العدو التكفيري ومواجهة نفس الطامع التركي، ورغم ان من قطع العلاقة هي جماعة يعاديها النظام بشكل رسمي!
ان احالة ملفات وجودية مثل سد النهضة على أمريكا أو مجلس الأمن، أو التعويل على دعم خليجي في هذا الملف وملف حماية الحدود، هو أمر عبثي وخطير، ونكرر أن الخطر الأكبر في الشرق، حيث الامن الاسرائيلي المتعارض مع الامن القومي المصري.
مصر بحاجة لثورة على نفسها وخياراتها وتحالفاتها سريعًا وعاجلًا، وهذه الثورة يمكن أن يقوم بها النظام كما قال الراحل الكبير "محمد حسنين هيكل". تتمثل في ضبط التحالفات ولم شمل الجبهة الداخلية بتغيير النمط الاقتصادي التابع، وتغيير مفهوم المصالح المتبادلة كأوراق للقوة، حيث أصبحت أوراق القوة تكمن في تعطيل المصالح الاستعمارية لا تبادلها، أو عقد صفقات تصورا انها تحيد الغرب عبر رشوته!
إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات
23/11/2024
لماذا تعرقل واشنطن و"تل أبيب" تسليح العراق؟
21/11/2024