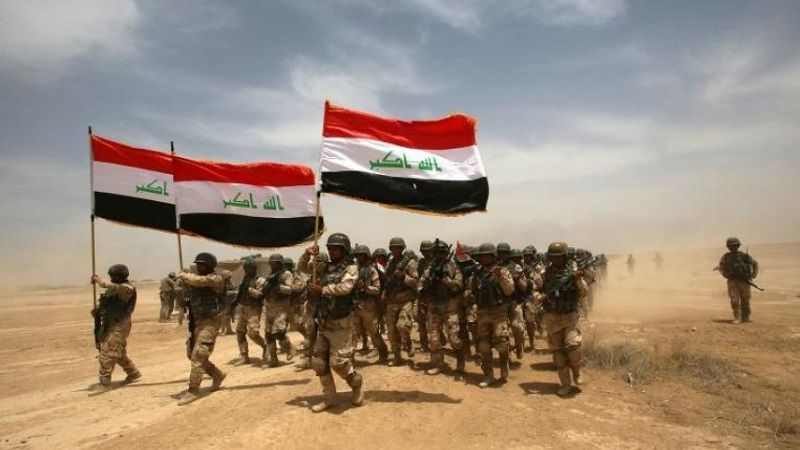آراء وتحليلات
"ماكينزي" والخراب الاقتصادي (1-2)
أحمد فؤاد
"الفاسد كالعميل".. كلمتان بميزان الذهب، كانتا في الزمان والمكان الأنسب، وسط احتجاجات شعبية تخبو وتتجدد في لبنان، وتشعل الحرائق بامتداد العراق، وجه سماحة السيد الأضواء والقلوب إلى حيث يجب أن تضع غضبتها، على سياسات الإفقار، لا الفقر، وعلى وصفات الخراب الأميركية، سابقة التجهيز والإعداد.
السيد أطل كما ألفه الشعب العربي، ممثلًا للكرامة العربية، الفوارة بالحركة القادرة على الفعل، الجالبة للانتصار لا النكسات، والذي وقف يومًا من أيام العام 2006، بوجه القوة العاتية الوحيدة والأولى على ظهر الكوكب، في زمن الترهل الروسي والانكفاء الصيني، والتيه العربي، وقف مطلع الأسبوع مجددًا، وأشار إلى مكمن الداء والخلل، بكلمات بليغة موجزة، سوف تعلق في الذاكرة العربية طويلًا.
أزمة الفساد لا تقل عن مصيبة الخيانة، كلاهما مدمر للشعوب بالقدر ذاته، وأثمان الفساد التي دفعها - ولا يزال - لبنان والمنطقة العربية آن لها أن تتوقف، بالحساب والعدالة، لا العفو، ومن أصدق ممن بذل الدم والجراح في سبيل الأوطان.
الذين ينظرون إلى ما يجري في الشوارع العربية، وما تموج به المجتمعات - حتى تلك المنغلقة في الخليج - ويتصورون أنهم أمام موجة ثانية من "ربيع عربي"، عليهم أن يعيدوا الكرة مرة أخرى، لعلهم يصلون إلى صورة أشمل، تضم حبات متناثرة لخطة تجري لسيطرة نهائية على المنطقة، بتفتيت المفتت، وتجزئة المجزأ، وترك الشعوب في غابة لا سبيل لديها للحياة سوى بالتهام غيرها.
الأزمة اللبنانية، الاقتصادية في قلبها، جزء من أزمة عربية شاملة، الوضع في لبنان لا يختلف عن مصر والسعودية والسودان، فقر وفقر ثم فقر، أورث الغالبية الكاسحة من الجماهير العربية بؤسًا غير مسبوق، وبلا نهاية منظورة، في ظل أنظمة حكم قررت استبدال مفهوم الحكم بالسيطرة، واستعاضت عن السيادة الوطنية بوكالة للأجنبي، وباعت شعوبها بأبخس الأثمان، وضحت بالدم والعرق على مذبح مؤسسات السيطرة المالية الدولية.
وفي الوقت الذي يعاد فيه رسم الخريطة العالمية، والعربية خاصة، وتحاول القوة الأولى الآفلة القيام بمهمة أخيرة - ومرعبة - وهي ضمان أمن الكيان الصهيوني للأبد، سواء بفرض صفقة القرن أو سواها من محاولات الإخضاع والتدمير، فإن العقل مدعو لوقفة تأمل في الحال الاقتصادي العربي، بالكامل، وسط عالم يسعى في سباق محموم نحو احتلال أو انتزاع مكان في المستقبل.
البداية لمناقشة أي أزمة اقتصادية هي الأرقام، وحدها محايدة، لا تنصر طرفًا إلا بحساب النتائج والمصير. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أعلنت الشهر الماضي، أن 40% من سكان الدول العربية تحت خط الفقر، إضافة إلى 25% من السكان أيضًا معرضون للفقر، أي أننا نتحدث عن ثلثي سكان المنطقة العربية، إما فقراء بالفعل أو في طريقهم للطبقة المسحوقة.
الرقم الأخطر في حساب الفقر هو خط الفقر المدقع، ووفقًا لتعريفه لدى البنك الدولي، فإنه عدم القدرة على توفير وجبة غذائية واحدة على الأقل يوميًا، بكلمات أبسط وأكثر رعبًا، العجز عن امتلاك الحد الأدنى الضامن للبقاء على قيد الحياة، وهذه النسبة كانت تدور حول 2.6%، لكنها تضاعفت إلى 5% مع عام 2016 فقط، ولم تفلح جهود احتوائها، وربما لن نتجاوز لو قلنا: لم تجر محاولة جادة لمنع هذه المأساة الإنسانية.
وبالإضافة للفقر، وما يستتبعه من فرض علاقة قهر على طبقة بعينها، تخرج من تحت مظلة رعاية الدولة، سواء بالدعم غير الموجود أو شبكة الحماية الاجتماعية الغائبة، فإن توزيع الدخل في المنطقة العربية هو الأسوأ على الإطلاق، حيث يحوز أثرى 10% من السكان على ما يفوق 65% (ثلثي) الدخل القومي، بينما يحصل 90% من السكان على الثلث فقط، وبالمقارنة بأوروبا القريبة، فإن أغنى 10% من السكان لا تزيد حصتهم في الدخل القومي عن الثلث فقط.
وفي إطار بحث الدول العربية عن "نموذج" لتنمية المجتمعات، يأتي دور شركة الاستشارات الأميركية العملاقة "ماكينزي آند كومباني"، التي تعمل في تقديم الاستشارات الاقتصادية للحكومة اللبنانية، كمكمل لدورها التدميري في الدول العربية، والتي سبقت لبنان إلى فخ ماكينزي.
وببساطة غير مخلة، فإن الشركة الأميركية، التي نشأت لتقديم وتطبيق استشارات المحاسبة على الإدارة، على يد أستاذ المحاسبة بشيكاغو جيمس ماكينزي، حوّلت ذهنية وفكر الأنظمة العربية من تلبس شخصية "حاكم" إلى "مدير"، وخلطت بالتالي بين الدولة والشركة، ووضعت الربح كقِبلة أولى يتحتم التوجه إليها، وهذا جائز ومطلوب في حال العمل الخاص بالطبع، لكنه يندرج تحت بند الجنون إذا ما سيطر على سياسة دولة تجاه مواطنيها.
وكمثال مجرد، يعني بقراءة النتائج والمخرجات، يمكن رد جلّ أزمات لبنان الاقتصادية إلى فلسفة "ماكينزي"، تلك التي سببت الخراب أينما حلت أو عملت، من السعودية إلى مصر والبحرين والإمارات وقطر، لا فرق، الفقر والبؤس ذاته موجود، والأنظمة تبتعد عن شعوبها، وتخاصم تطلعاتها وأمانيها، والوعود كلها سراب يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا حل الموعد لم يجده شيئاً.
ومن السعودية نبدأ، أكبر اقتصاد عربي، بناتج محلي إجمالي (GDP) 683.8 مليار دولار، وهو ضعف الإمارات التي تليها بالقائمة بنحو 382 مليار دولار فقط، والتي أعلنت "رؤية 2030" على لسان ولي عهدها محمد بن سلمان، وهي نسخة كربونية من دراسة أعدتها "ماكينزي" للسعودية حتى عام 2030، والخطوط العريضة للورقتين متطابقة، وهي: تقليل الاعتماد على النفط، خلق قطاع خاص قادر على قيادة الاقتصاد الوطني، وتحين تنافسية الاقتصاد، وتقليل الدعم عبر خطط تقشفية واسعة.
ومنذ اعتماد "رؤية 2030" بالسعودية، تطالعنا البيانات الحكومية، والوسائل الإعلامية، بتقارير الإشادة من المؤسسات المالية العالمية، إلى الدرجة التي فاقت حدود المنطق، حتى أصبحت التقارير مجالًا للتندر على مجافاة الأرقام لحقائق الواقع في المجتمع السعودي.
الإحصائيات غير الرسمية لعدد الفقراء بالمملكة، تقدر عددهم بنحو 3 ملايين مواطن، ما يعادل 18% من التعداد السكاني، وهي احصائيات تقريبية، تشمل العاطلين عن العمل، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وأصحاب الأجور المتدنية، وتُشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأثرياء لا تتجاوز 0.6 % من المجموع الكلي للسكان، و نسبة المدراء و المشرعون لا تتجاوز 6%، في حين تصل نسبة الطبقة العاملة إلى 44%، وهي أرقام توضح أن هناك اتساع للطبقة الفقيرة بمرور الزمن، لا يكفي لحلها مجرد مسكنات.
ويستمر "الأمير" في تبديد الثروة السعودية، بسرعة واستهتار شديدين، وخلال السنوات الأربع الماضية، منذ تسلمه مقاليد الاقتصاد والمالية السعودية، جرى سحب نحو 180 مليار ريال خلال 2016 من الاحتياطي العام، ما أدى إلى تراجعه بنسبة 28%، ليبلغ 474 مليار ريال فقط بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، فيما كان نحو 654 مليار ريال نهاية 2015، وطريق الاقتراض الخارجي بدأ، كقطار يمضي في طريقه بلا توقف، فالعجز يجلب الديون، التي تجذب بدورها التدخلات الاقتصادية في شؤون البلد، وتزيد من الارتهان والتبعية.
ومن واقع الأرقام الحكومية المعلنة، حققت المملكة معدلات تضخم مرتفعة، ونسب بطالة بين الشباب غير مسبوقة، رغم كل جهود السعودة، وحقق الاقتصاد خلال عام 2017، نموًا عند 0.2% فقط، وهو واحد من أقل معدلات النمو المسجلة في تاريخ المملكة كله، وارتفعت قيمة الدَّين العام حتى نهاية السنة الماضية، حسب بيانات موازنة 2018، إلى 438 مليار ريال، مقابل 316 مليار ريال نهاية 2016.
ولم يكن غريبًا أن تؤدي النتائج المحققة إلى احتلال السعودية المركز التاسع في قائمة أكثر الاقتصاديات بؤسًا لعام 2019، والتي تصدرها شبكة "بلومبرج" الاقتصادية الرصينة، ويقيس المؤشر نسبتي التضخم والبطالة، كأكثر المؤشرات تماسًا مع حياة المواطن العادي وعصفًا بأيامه البائسة، وتبقى أفضل وأكمل حكم على إصلاحات النظام السعودي تحت وصاية "ماكينزي" وغيرها من مؤسسات السيطرة العالمية القذرة.
الغريب أن قادة السعودية مصممون على الاستمرار في إصلاحهم الجنوني، حتى النهاية. فالرؤية الصادرة بلا أي استناد لمعطيات، والتي تم إخراجها بشكل مثير لا ينفي عدم واقعيتها، تستند إلى خصخصة قطاعات الاقتصاد السعودي، أي تقليل الاعتماد على النفط، مقابل إيجاد مداخيل أخرى للدولة، لكن واضعها قرر القيام بذلك عن طريق التخلص من مشكلة أن عائدات الدولة تأتي من النفط، ببيع شركة النفط العملاقة "أرامكو"، ورغم تأجيل وفشل الطرح في بورصات العالم، فقد أعلنت السعودية طرح شركتها الأهم في البورصة السعودية، وقبلت بتقييم يتراوح بين 1.2 إلى 1.8 تريليون دولار لأضخم شركة نفط على وجه الكوكب، وفقدت نحو تريليون دولار مقدمًا وقبل الطرح، بعد تأكيدات على أن الشركة تساوي أكثر من 2.2 تريليون دولار.
المؤسسات المالية العالمية، بقدرتها على النفاذ إلى الأوطان، وربط اقتصادياتها بالدولار، وطبع القيادة بالشكل الغربي المقيت، نجحت في جعل المنطقة العربية مستودعًا للأزمات، وكلما بدأ دولة ما الخروج من أسر التبعية، سارع الغرب بإشعال ما زرعه ورعاه سابقًا، لنبدو وكأننا نحارب أنفسنا ودولنا، بدلًا من الاتجاه للعدو الحقيقي.
إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات
23/11/2024
لماذا تعرقل واشنطن و"تل أبيب" تسليح العراق؟
21/11/2024